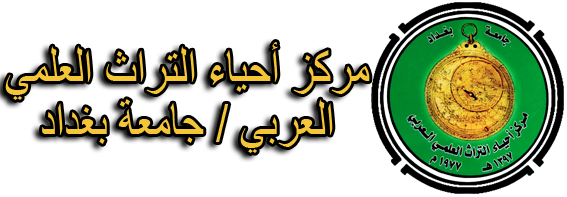رحلة أبو مروان الباجي الى الحج
كان الاندلسيون يسلكون عدة للوصول الى الديار المقدسة في الحجاز منها طريق الشام ، إذ كان الحجاج الأندلسيون يتوجهون مباشرة إلى الشام ليلتحقوا بركب الحاج الشامي المتجه إلى مكة المكرمة . ومن الأمثلة على ذلك رحلة حج محمد بن احمد بن عبد الملك أبو مروان الباجي (ت 635هـ/1237م) ، وهو اندلسي من أهل اشبيلية ، وكان من الموصوفين بالفضل والخلق الكريم ، ومن المهتمين بالحديث واللغة العربية وآدابها ، له رحلتين إلى الحج، كان طريقه في الاولى عبر دمشق، ولما عاد إلى الأندلس تولى القضاء في عهد أمارة أبي العلاء ادريس بن المنصور من آل عبد المؤمن. وعندما أراد الحج مرة ثانية باع أملاكه في اشبيلية وخرج منها في سنة 633هـ/1235م إلى سبتة ، ومن بر العدوة اخذ مركب رومي ، وابحر في يوم الأربعاء السادس من شهر محرم سنة 634هـ/1236م ، وكان طريق المركب مالقة ،ثم المنكب، ثم المرية، ثم قرطاجنة، ثم لقنت، ثم فارق بر الأندلس إلى جزيرة يابسة ، ثم ميورقة ، فدخل المركب مرساها ليلة الخميس الثالث والعشرين من محرم ، وأبحر منه مساء الخميس إلى جزيرة فبريرة ، وفيها بات ليلة الجمعة ، وفي صباح يوم الجمعة أبحر المركب إلى مرسى سردانية، ودخلها يوم الثلاثاء الرابع من شهر صفر ، وأبحر يوم الخميس السادس من صفر إلى صقلية ، فتجاوزها المركب ، الا أن الريح ردته إلى مرسى سرقوسة أحد مدن صقلية، فدخلها ليلة الأربعاء الثانيةعشرة من صفر ، وبقي فيها حتى يوم السبت السابع من ربيع الأول ، ثم نزل سرقوسة وبقي مقيم فيها من ليلة الأحد الثامن من ربيع الأول حتى يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة ، ثم انتقل إلى المركب بانتظار رياح مناسبة لسيره، فأبحر يوم الأربعاء إلى جزيرة اقريطش في ثمانية أيام ، ثم إلى جزيرة قبرص في خمسة أيام ، ثم إلى عكا في ثلاثة أيام ، وكان معدل سير المركب من سرقوسة إلى عكا مائة ميل ، فوصل المركب إلى عكا في يوم الأربعاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب ، ومن عكا إلى دمشق في السابع من رمضان ، واقام فيها حتى منتصف شوال .
خرج أبو مروان الباجي مع الركب الشامي في منتصف شهر شوال إلى مكة المكرمة، وكان طريق الركب عبر بصرى التي وصلها بعد أربعة أيام ، ثم إلى الازرق،ثم تيماء، ثم خيبر، ثم المدينة إذ زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقي فيها مدة يومين، وبعدها فارق الركب الشامي ، واتجه إلى وادي العقيق ، وبئر علي ، وذي الحليفة ومنها احرم إلى شعب علي، ثم إلى بدر ، ثم إلى رابغ ، ثم إلى الجحفة، ثم الى بطن مر، ثم إلى مكة التي وصلها في اليوم الرابع من ذي الحجة ، ونزل الابطح .
وكان طريق عودته عبر مصر ، إذ وصل إلى جدة، وركب البحر منها إلى سلق في يوم وليلة وسار صاعدا إلى دبادب ،ومنها إلى البر وسار لثمانية أيام إلى عيذاب ، وأقام بها ثمان وعشرين يوما، ثم قطع الصحراء إلى قنا في عشرين يوما ، وكان يسير مع جماعة عددهم سبعين رجلا ثم وصل إلى قنا ، ومنها إلى قوص، ولما عرف الملك الكامل بخبره أمر بإحضاره ، فحمله والي قوص في مركب عبر النيل إلى اخميم ، ثم منية بن خصيب إذ بات فيها ليلته ، ثم إلى مصر ، وعندها يكون قد قطع المسافة من قوص إلى مصر في سبعة أيام، فنزل في خان ابن الرصاص ، ومات في ليلته سنة 635هـ/1237م .
ورحلة ابو مروان الى الحج صورة رائعة عن الحجاج الاندلسين الذين يرغبون في اداء فريضة الحج على الرغم من الظروف السياسية المضطربة في تلك الفترة ، والمخاطر التي يتعرض لها الحجاج ، فضلا عن طول المسافة .
مقاله (الرحلات العلمية بين البصرة وبلاد المغرب العربي الاسلامي)
كانت للرحلة في التاريخ العربي الاسلامي أهداف متعددة في مقدمتها الحج الى بلاد الحجاز حيث مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتجارة، وحب السفر والانتقال بين البلدان، وطلب العلم . والرحلة في طلب العلم أحد أهم ميزات الحضارة العربية الاسلامية، وفي كثير من الاحيان يجمع أكثر من هدف في الرحلة الواحدة .
ومع الأخذ بنظر الاعتبار صعوبة السفر وبعد المسافة، يتضح لنا الجهد الكبير الذي بذله الرحالة في سبيل الوصول الى غايتهم، ولاسيما الرحلة العلمية التي تتطلب من أجلها أن يبقى طالب العلم مدة أطول، ويبذل جهد أكبر، وان ينتقل بين بلد واخر من أجل اللقاء بأحد العلماء، فضلا عن ان البعض كان يعمل الى جانب الدراسة .
والعراق أحد البلدان التي كان طلبة العلم يقصدونها ، لأن المدرسة العراقية تميزت بعلماء على درجة عالية من العلم، لذلك كان الطلبة يتهافتون من أجل الأخذ منهم والالتحاق بحلقات درسهم ، والبصرة أحد المدن العراقية التاريخية التي تركت أثر مهم في الحضارة العربية الاسلامية لما تميزت به من الانتاج الفكري في مختلف الميادين .
وصل الى العراق ولاسيما مدينة البصرة اعداد كبيرة من طلبة العلم المغاربة، الذين كان البعض منهم ليسوا طلبة علم مبتدئين بل علماء رحلوا الى بلدان المشرق العربي الاسلامي ومنها العراق وبعضهم قصد مدينة البصرة منهم :
احمد بن دحيم بن خليل من مدينة قرطبة الذي سمع في مدينة البصرة من ثلاثة من علمائها ، محمد بن عبد السلام الخشني الذي سمع في مدينة البصرة من ( 25) عالماً – وفي البحث سيأتي ذكر الاخرين الذين دخلوا الى مدينة البصرة – .
ومنذ النصف الاول من القرن الهجري الثاني أخذت اراء مالك بن أنس الفقهية تدخل بلاد المغرب العربي الاسلامي والاندلس، وغدا المذهب الرسمي في تلك النواحي، والعراق احتضن اهم علماء الفقه المالكي حتى نهاية القرن السادس الهجري في مدينة بغداد ، مدينة واسط ، وفي البصرة تحديدا كان ابراهيم بن سعيد البصري المالكي الذي درس عليه ابن حزم الاندلسي أحد اعمدة الفقه المالكي .
كذلك كان كبار علماء الخوارج في المغرب العربي الاسلامي يحثون طلبتهم للتوجه الى مدينة البصرة لاخذ تعاليم الفكر الخارجي من ابي عبيدة سلم بن أبي كريمة التميمي ( مولى بني تميم ) فسلمة بن سعد اول داعي للفكر الاباضي في المغرب العربي الاسلامي يوجه طلبته الاربعة عبد الرحمن بن رستم وعاصم السدراتي ، واسماعيل بن درار الاندلسي ، وداود النبلي النفزاوي للذهاب الى البصرة .
وان طلبة العلم الذين درسوا في مدرسة العراق لهم مكانتهم المميزة عند عودتها الى بلادهم فهذا الخليفة الحكم المستنصر يعمل على استدعاء طلاب الرحلات العلمية الى العراق بعد العودة الى بلادهم للافادة من كفاتهم العلمية المكتسبة من العراق في بناء الاندلس .
ومما لاشك فيه ان العلم في مدرسة العراق له سمته الخاصة بين كل البلاد العربية الاسلامية حتى أن ابن حزم الاندلسي ميز العراق علميا عن كل البلاد العربية الاسلامية المشرقية ووصفه بأنه ينبوع المعرفة لدى المشرقيين والمغربيين .
وفي مجال العلوم اللغوية يعد أبو بكرمحمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي (ت379هـ) الفقيه العالم اللغوي النحوي الذي وخير ما يمكن ان يذكر ان اهل المغرب في مناظراتهم النحوية واختلافهم على بعض المسائل يكون حكمهم هو مدرسة البصرة والكوفة النحويتين وذلك يدل على المكانة المهمة لمدرستي البصرة والكوفة النحوية في بلاد المغرب العربي الاسلامي والاندلس .
وكذلك الجوانب العلمية التي لايمكن اغفال أثر مدرسة العراق ولاسيما البصرة في ازدهارها في بلاد المغرب العربي الاسلامي والاندلس .
ولابد من الاشارة الى أن هنال رحلات من العراق الى بلاد المغرب العربي الاسلامي والاندلس، وكان لهم مكانتهم المميزة وتأثيرهم الواضح في المجتمع فالوالي يزيد بن حاتم ومن بعده الامراء الاغالبة قدموا الدعم للفقهاء العراقيين في القيروان ولاسيما في عهد ابراهيم بن الاغلب ، كذلك كان اهتمام الادارسة، فادريس الثاني كان حريصاً على استقبال العراقيين واكرامهم في بلاده . وكذلك الحال في الاندلس .
مقاله ( الاثر العلمي لابن الهيثم على الحضارة الأوروبية )
ابن الهيثم هو : محمد بن الحسن بن الهيثم، كنيته ابو علي، من أهل البصرة، ولد عام 354هـ/ 965م، نشأ في مدينة البصرة وعمل كاتباً، ثم ترك العمل في الدولة من أجل التفرغ لطلب العلم. ثم انتقل الى مصر في عام 386هـ / 996م، حيث عاش هناك وتوفي، ودرس مجرى النيل. وصفه البيهقي في كتابه فقال : ” إنه من أهل العبادة والورع ومحبا للعلم ” . ويعد ابن الهيثم من العلماء العرب المسلمين الموسعيين، فهو عالم في الهندسة والفيزياء والبصريات وعلم الضوء والطب والفلسفة وله آراء في بعض المسائل الدينية .
وهو من العلماء الذين لهم الفضل على الحضارة الأوروبية، لأن علمه ساهم في نهضتها، فقد أنتشر علمه في الغرب في الهندسة والرياضيات والطب والبصريات، فكان الاستاذ الذي له السبق والاصالة والابداع، وكثرت النقولات من كتبه في البصريات والفلك والفيزياء، لاسيما في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي من قبل العلماء الأوروبيين، مما كان له الأثر في المساهمة في تحقيق النهضة العلمية المعاصرة، حتى انهم لقبوه ” الهازن ” .
ذكره الكثير من الكتاب الغربيين ولم يختلفوا حول مكانته ومنزلته، ومنهم جورج سارتون، وجوزيف هل في كتابه الحضارة الاسلامية ، والمستشرق دى بورفي في كتابه تاريخ الفلسفة الاسلامية، وكاجوري في كتابه تاريخ الفيزيقا، وجارلس جروسي في كتابه الطب الاسلامي، فقد أكدوا جميعاً أن الأوروبيين أفادوا من نظريات ابن الهيثم .
إن أهم انجازات ابن الهيثم من الناحية الطبية بحثه في تركيب العين، فقد وصف طبقاتها ورطوبتها، وكذلك الدماغ والمخ وله في الطب خمسة كتب . وذكر الابصارمن الناحية النفسية كالمعاني المبصرة الجزئية والمركبة، فقد ذكر العمليات النفسية المرتبطة باستيعاب المرئيات ، وأكد ببحوثه آراء مهمة عن القيمة النفسية، وله مؤلفات مهمة متعلقة بهذا الجانب .
وفي الرياضيات والهندسة ذكر كيلي في كتابه تاريخ الفلك أن مؤلفات ابن الهيثم لها طابع رياضي، ولاسيما في الهندسة، وتبدو واضحة عندما درس خواص التناسب، وأطلق اسم طرفي التناسب . أما درك سترويك عالم الرياضيات فذكر أن ابن الهيثم قدم دراسة مهمة عن طريق تعيين موقع صورة نقطة مضيئة في مرآة مستوية، وعند تحليل الموضوع نحصل على ما أطلق عليه مسألة الهيثم، وهي كيفية رسم خطين في مستوى دائرة يتلاقيان في نقطة على محيط الدائرة ويصنعان زاويتين متساويتين مع الخط العمودي على المماس وذلك معناه معادلة جبرية من الدرجة الرابعة .
إن ابن الهيثم له اسهام أصيل في حل معادلة جبرية هي د (س) = صفر التي سماها طريقة التوسط، وقد أفاد من الهندسة لغرض الحصول على الجذور الحقيقية، وفي الوقت الحاضر أهتمت الجامعات اليابانية، وهو بذلك أسبق من ديكارت، ومن اسهاماته تطويره مجموعة المتسلسلتي الأس الثالث والأس الرابع للأعداد الطبيعية، وفي هذا المجال كانت له مؤلفات عديدة .
اهتم ابن الهيثم بعلم الفلك فكان له ابداعاته، حيث كتب رسائل الى بعض الحكام يحثهم فيه على بناء المرصد للنجوم، وترك ابن الهيثم مؤلفات عديدة وصلنا منها سبعة عشر مقالة من أربع وعشرين . وأهم من ترجم لابن الهيثم الفونسوا الحكيم عام 1277م الذي اعتنى بترجمة كتابه (في هيئة العالم) الى اللغة القشتالية، ومن المواضيع التي ذكرها ابن الهيثم عن الفلك، أبعاد الاجرام السماوية وأحجامها وحركاتها وكيفية رؤيتها وارتفاع القطب وماهية الأثر على وجه القمر، وبفضل عنايته بهذه العلم أطلق عليه لقب بطليموس الثاني .
ومن الأمور المهمة الأسلوب المنهجي العلمي المعاصر الذي يرجع الى ابن الهيثم، حيث اثبت البحث ان ابن الهيثم أسبق من فرنسيس بيكن في ذلك .
أما عن علم المناظر (البصريات) فإن كتابه المناظر من أشهر كتبه في البصريات، وكيفية الرؤيا، ويتكون من سبع مقالات، وقد ترجم عدة مرات اقدمها ترجمة جيرارد الكريموني في طليطلة، وطبعت في لشبونة عام 1542م، كما طبع عام 1572م في مدينة بال السويسرية ، ومن آراء ابن الهيثم ونظرياته في الضوء إنه ينبعث من جميع النقاط على سطوح الاجسام على شكل خطوط مستقيمة غير منكسرة، والشعاع، وقوة الضوء وعن نفاذه في الاجسام الشفافة، وإنه لاينفذ في الاجسام الكثيفة . وعن انعكاس وانكسار الضوء، والحيود، وطريقة الابصار والتأكيد بشكل قطعي على أن الابصار لايكون بشعاع يخرج من البصر الى المبصر، وان المبصر يجب أن يكون مضيأ إما بذاته أو بإشراق ضوء من غيره، وأن يكون بينه وبين العين مسافة، وأن يكون بين كل نقطة من سطح البصر وبين العين خط مستقيم غير منقطع بشئ كثيف، ثم استدل من ذلك على ان السبب الاساسي في الابصار هو وجود المبصر مع توفر هذه الشروط .
وعلى الرغم من أن الاثر العلمي لابن الهيثم على الحضارة الأوروبية يظهر جليا من خلال علم البصريات الذي كان رائدا فيه واقتبس منه الأوروبيين الكثير، فقد قدم اراءه في أبحاثه عن الضوء والبصريات وبعض الظواهر الطبيعية المستندة على الضوء مثل قوس قزح والفجر والشفق والهالة والبيت المظلم، إلا إن البحث أثبت أن قصر أثره العلمي على الحضارة الأوروبية في مجال البصريات فيه ظلم كبير له، لأن مساهماته العلمية لايمكن ان تقتصر على البصريات فقط، فقد أثبت البحث مساهمته وأصالة أفكاره وآراءه في أكثر من علم .
مقاله
منهج ابن هُذيل في كتابه
” حلية الفرسان وشعار الشجعان “
يعد كتاب حلية الفرسان وشعار الشجعان أحد المواضيع التي تسلط الضوء على حقبة تاريخية مهمة في التاريخ العربي الاندلسي، لكثرة مافيها من الاحداث والاضطرابات السياسية، التي تلزم الباحث بالاطلاع على مصادر تلك الحقبة أو المصادر القريبة منها ، حتى يتمكن من الوصول الى ماهو أقرب الى الحقيقة. وعلى الرغم من ان عنوان الكتاب يوحي بأنه يهتم بجانب معين، إلا ان الكتاب غني بمعلومات سياسية وادبية واجتماعية واقتصادية يمكن أن يصل اليها الباحث من خلال استقراء النصوص فيه.
الكتاب مطبوع متداول مشهور ، إلا انني وجدت أنه بحاجة الى دراسة علمية دقيقة تعطي المؤلف والكتاب حقه، فالطبعة التي اخرجها لوى مرسى فهي من باب قديمة وليس فيها من جهد، إلا السبق العلمي إذ عمل على نشرها ليوجه عناية الدارسين الى وجودها في الاسكوريال، أما الطبعات الاخرى فلم أتمكن من الوصول اليها .
وحسب علمي المتواضع لم اجد أن هناك دراسة أو بحثاً أكاديمياً يتناول حياة المؤلف ومنهجه وقيمته العلمية واسلوبه في تدوين مؤلفاته، وحسم الخلاف بين الكتاب للخلط بينه وبين اخرين لهم ذات اللقب – ابن هذيل – .
وعلى الرغم من قلة المادة التاريخية المتوافرة عن حياته الخاصة ، الاان ذلك لم يكن ليمنع من الكتابة .
توصل البحث المعنون ” منهج ابن هذيل في كتابه حلية الفرسان وشعار الشجعان ” الى بعض النتائج المهمة منها –
أنه من الكتب القيمة عن الخيل لمؤلف من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي، لأن معلوماته دقيقة وشيقة، ففيه ورد خلق واسماء الخيل واسلوب التمرس على ركوبها والدخول في سباقاتها، وحمل بين طياته الادب والشعر واللغة . فضلا عن ذكر للسلاح المستخدم في ذلك العصر من السيوف والنبال …الخ .
ومن هنا جاءت اهمية الكتاب من انه ارخ لفترة غاية في الاهمية التاريخية في بلاد الاندلس .
وانه بالامكان الاعتماد على مادته في التوصل الى بعض المعلومات عن تلك الفترة ليس من الجانب السياسي فقط بل جوانب مختلفة منها الاجتماعية ، والاقتصادية كما انه نموذج جيد يعكس طبيعة الكتاب والكتابة ومميزاتها .
وعلى الرغم من المؤلف له اكثر من كتاب الا ان منهجه متقارب في معظمها وان الاختلاف كان في طبيعة الموضوع .
ولابد من اعطاء ابن هذيل حقه في انه تحلى بالامانة العلمية في جمع كتابه ( حلية الفرسان وشعار الشجعان ).
ولابد من الاهتمام بالمؤلف وكتبه والتعمق في دراستها وتحقيقها ، لفائدتها العلمية للعصر الذي دونت فيه .